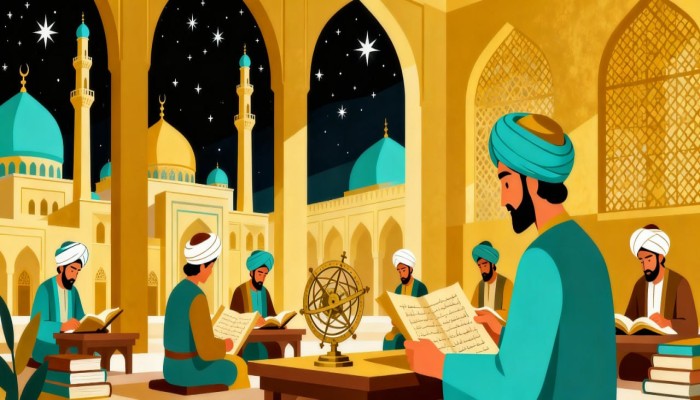واقع الأمة الإسلامية المعاصر لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج ترسبات كثيفة تراكمت عبر أزمنة تاريخية طويلة، شملت العقيدة والتصورات والتربية والممارسات الاجتماعية والسياسية.
وفي هذا التقرير، يستعرض الشيخ أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب في كتابه الإسلام وهموم الناس، فهم هذا الواقع المعقد الذي يتطلب قراءة عميقة لهذه الترسبات والوقوف على تفرعاتها وأسبابها، حتى يصبح تجاوزها ممكناً عبر معالجة دقيقة شاملة ومتكاملة. لقد دلفت الأمة إلى واقع القصعة الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر حقب متتالية وبفعل عوامل متعددة، لعل من أهمها انحسار خلق تبني همّوم الناس من واقع الأمة.
غفلة خطيرة عن المبتدأ الأول
إن أخطر ما أصاب الأمة هو الغفلة عن حقيقة أساسية: التشريع في الإسلام مبني على الاعتقادات. هذا هو السر وراء أن القرآن المكي ركز على بناء العقيدة وجدانياً وعقلياً لمدة ثلاثة عشر عاماً، تمهيداً للتشريع الذي كان سمة القرآن المدني الأبرز. موضوع القرآن المكي الأساسي كان تعريف الناس بربهم الحق، وتنحية ما أدخل على العقيدة الفطرية من غبش وانحراف، ورد الناس إلى إلههم الذي يستحق الدينونة.
التركيز على العقيدة لم يكن عبثاً، بل لأن الأخلاق والسلوك لا تقوم إلا على أساس من عقيدة تضع الموازين وتقرر القيم والسلطة التي تستند إليها هذه الموازين. قبل تقرير هذه العقيدة وتحديد هذه السلطة، تظل القيم كلها متأرجحة، وتظل الأخلاق بلا ضابط ولا سلطان ولا جزاء. هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته، ويجعل بناء العقيدة وتمكينها وشمولها لشعاب النفس ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة، وضماناً من ضمانات الاكتمال والتناسق بين الظاهر في عالم المعاملات والكامن في عالم الاعتقادات والتصورات.
مشاريع نهضوية فاشلة ومجتمعات خامدة
أدت الغفلة عن هذه الحقيقة الجوهرية إلى اضطرابات جسيمة في واقع المسلمين. طوائف من أبناء الأمة اختطفهم عالم الأشياء وأذهلهم عن كينونة أمتهم، فراموا تطبيق مناهج نهضوية لا تبدأ من هذا المبتدأ. خمول جماهير الشعب يمكن التغلب عليه إذا كان راجعاً إلى مجرد التجنب الفطري للكد وبذل الجهد، لكن لا يمكن التغلب عليه إذا كان يعبّر عن الرفض لنفس المثل الأعلى للكفاح، لكونه مضاداً لصميم إرادة عامة الشعب وإحساساتهم.
الشعوب الإسلامية لن تقبل أبداً بأي شيء يخالف الإسلام مخالفة صريحة، لأن الإسلام ليس مجرد فكرة وقانون، بل أصبح في نفوس هذه الشعوب محبة وشعوراً. كل من خرج على الإسلام، كائناً من كان، فلن يحصد غير الكراهية والمقاومة. ولهذا السبب بقيت كل المشاريع النهضوية المطروحة عالقة، وأصيبت الأمة بالخمول من جراء اللامبالاة وعدم اكتراث الشعوب، مما ضيع جهوداً وهدر مقدرات الأمة في أمسّ الحاجة إليها.
القطيعة الكبرى: الدولة المحدثة والعلمانية
عقب اختفاء النموذج الإسلامي للوجود السياسي الذي كانت تعبّر عنه الدولة العثمانية رغم تدهورها في أخريات أيامها، برزت "الدولة المحدثة" التي شكلت قطيعة حادة مع الوظيفة العقيدية في جوهرها النقي، نتيجة تبنيها العملي لمبدأ العلمانية اللادينية وتطبيقه في كافة أمورها السياسية داخلياً وخارجياً. مع ذلك، فإن مضمون الوظيفة العقيدية وأبعادها ترسبت في الوعي والذاكرة الجمعية لطوائف الأمة، ليشكل رصيداً ثابتاً على مستوى العقيدة والقيم والسلوك الفردي والجماعي، وإن كان لا يجد تعبيره السياسي في الوقت الراهن.
هذه "الدولة المحدثة" في البلاد الإسلامية نتاج عملية التحديث على النمط الأوروبي، الأمر الذي جعل منها إطاراً فوقياً مركباً على قمة المجتمع يحكمه وهو منفصل عنه. وهي محدثة لأنها تشكل انحرافاً أو ابتداعاً في عقيدة المجتمع الأساسية والسائدة، التي كان ينبغي للدولة أن تكون أداة ووسيلة لتحقيقها في الواقع.
الأمة انبثقت من العقيدة والدولة كانت نتاجاً
الأمة الإسلامية انبثقت من عقيدة التوحيد الجامعة، التي رسمت الخطوط الأساسية والأطر العامة التي يُهتدى بها في عملية تأسيس البناء. هذه العقيدة هي التي وضعت مبادئ النظم وقواعدها، وحددت مجالات الممارسة والحركة، لتكون الدولة نتاجاً ومحصلة طبيعية لهذا المجتمع العقيدي. من البديهي أن تلتزم الدولة بأساس وجودها العقيدي الذي قام عليه المجتمع، وأن تجعل غايات حركتها وممارستها السياسية نابعة من الغايات التي تحددها العقيدة، فتصبح الدولة أداة أو وسيلة لتحقيق تلك الغايات من خلال ترجمتها في عمليات وأدوار ووظائف محددة.
غياب هذه الأمور أدى إلى شلل المجتمعات الإسلامية، وكان من آثاره انحسار خلق تبني همّوم الناس من واقعنا.
التحرير الوجداني: القاعدة الصلبة للنهضة
هذا الدين قبل أن يكسب الإنسان حقوقه، بنى عقيدته وحرره وجدانياً. حرر الإنسان المؤمن من عبادة غير الله ومن الخضوع لأحد سواه، فما لأحد عليه غير الله سلطان، وما من أحد يميته أو يحييه أو يملك له ضراً أو نفعاً إلا الله، وليس بينه وبين الله وسيط ولا شفيع.
التحرر من الخوف على الحياة
إذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله، وامتلأ بالشعور بأنه على اتصال كامل بالله، لم يتأثر بشعور الخوف على الحياة أو الرزق أو المكانة. هذا الشعور الخبيث يغض من إحساس الفرد بنفسه، وقد يدعوه إلى قبول الذل والتنازل عن كرامته وحقوقه. لكن الإسلام لشدة حرصه على تحقيق العزة والكرامة للناس، يعنى عناية خاصة بمقاومة الشعور بالخوف على الحياة والرزق والمكانة.
القرآن يقرر: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا﴾، ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا﴾، ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. إذن فلا كان الجبن والجبناء، فالحياة والأجل والنفع والضر بيد الله دون سواه.
التحرر من الخوف على الرزق
القرآن يقرر: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم﴾. ويقرر أن خوف الفقر إنما هو من إيحاء الشيطان ليضعف النفس ويصدها عن الثقة في الله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾.
التحرر من الخوف على المكانة
القرآن يتتبع في نفس الإنسان كل ذرة من خوف أو قلق من شأنها أن تحجم به عن طلب المعالي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقرار الحق. فيزيل الخوف على المكانة بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ﴾. ويعالج الإحساس بقلة القدر أمام الأشراف بقوله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
التحرر من استعباد المال
يعالج القرآن النفوس المريضة بالإحساس بالصغار أمام أرباب الأموال بقصة قارون: ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ... فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ... وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾. ويقول: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾.
التحرر من استعباد العلائق
قد يتحرر الإنسان من كل ما سبق حين تستتب العقيدة في قلبه، لكن يبقى مستذلاً لذاته وشهواته وعلائقه، فيستأصل الله هذا الإصر بقوله: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾.
هكذا يجمع في آية واحدة جميع اللذائذ والمطامح والرغائب ونقاط الضعف في نفس الإنسان، ليضعها في كفة، ويضع في الكفة الأخرى حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، لتكون التضحية كاملة والتخلص من أوهاق الشهوات كاملاً. النفس التي تتحرر من هذا كله هي النفس التي يتطلبها الإسلام لتستعلي على الضراوة المذلة وتملك قياد أمرها وتنزع إلى ما هو أكبر من الرغبات الوقتية الصغيرة.
ليس زهداً بل تحريراً وانطلاقاً
هذا ليس تحذيراً ولا دعوة إلى الزهد وترك طيبات الحياة، بل دعوة للتحرر والانطلاق من ضعف الشهوات والغرائز. ثم لا ضرر بعد ذلك من الاستمتاع بالحياة حين يملكها الإنسان ولا تملكه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾، ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.
الخلاصة
فهم واقع الأمة المعاصر يبدأ من فهم أن العقيدة هي الأساس الذي تُبنى عليه كل مشاريع النهضة الحقيقية، وأن أي مشروع يتجاهل هذا الأساس محكوم عليه بالفشل مهما امتلك من أدوات مادية. التحرير الوجداني للإنسان من كل أشكال الخوف والاستعباد هو المدخل الصحيح لبناء مجتمع حر قادر على تبني همّوم الناس والنهوض بالأمة.