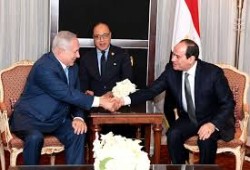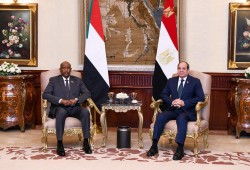لم يكن مشهد يناير 2011 مجرد حلقة عابرة في سلسلة "الربيع العربي"، بل كان حدثًا مصريًا خالصًا نبع من عمق تكوين المجتمع وعلاقته التاريخية المعقدة بالسلطة المركزية. الثورة المصرية، بخصوصيتها المتفردة، لم تنطلق من ثكنات عسكرية ولا صالونات نخبوية، بل انفجرت من قاع مجتمع صبور، اعتاد لقرون طويلة تحويل الألم إلى نكتة، والصمت إلى حيلة للبقاء، حتى جاءت اللحظة التي قرر فيها تحويل الفضاء العام إلى ساحة للسياسة، والسخرية إلى فعل مقاومة صريح.
لقد كانت يناير "ثورة مجتمع" قبل أن تكون ثورة سياسة، حيث أعاد المصريون تعريف علاقتهم بالدولة، محطمين هيبتها المتراكمة عبر احتلال "عقلها" الرمزي في ميدان التحرير، في تجربة فريدة جمعت بين عظمة اللحظة وهشاشة المسار.
ميدان التحرير.. استعادة الدولة ونزع الشرعية
لم يكن اختيار "ميدان التحرير" كنقطة انطلاق وارتكاز للثورة مجرد صدفة جغرافية، بل كان خيارًا واعيًا نبع من الذاكرة الجمعية للمصريين تجاه "الدولة المركزية". في مصر، تتمركز السلطة تاريخيًا في العاصمة، وتتجسد هيبتها في قلب القاهرة حيث تتركز المؤسسات والبيروقراطية والأمن. لذا، كان احتلال الميدان بمثابة ضربة مباشرة للمركز العصبي للدولة المتضخمة.
إن السيطرة على الميدان لم تكن مجرد فعل احتجاجي، بل كانت عملية "نزع شرعية" كاملة عن النظام. فعندما وجد النظام نفسه خارج الميدان، بينما الشعب بكل أطيافه داخله، كانت الرسالة واضحة: "هذه الدولة ليست أنتم.. هذه نحن". تحول الميدان إلى "دولة بديلة" واستعادة معنوية للوطن الذي احتكرته السلطة لعقود، وسيطرت فيه على الاقتصاد والإعلام والأمن. في تلك اللحظة، أصبح الحشد البشري الهائل هو الممثل الشرعي الوحيد، معلنًا كسر احتكار السلطة للمشهد العام، ومقدمًا نموذجًا لمصر كما يريدها أبناؤها: متنوعة، حية، وملكا للجميع.
من "النكتة" إلى "الكسر".. سيكولوجية الصبر المصري
لفهم كيف انفجرت الثورة بهذا الشكل الواسع والمفاجئ، يجب النظر إلى طبيعة المجتمع المصري كمجتمع "صبور" لا يميل للانفجار السريع. هذا الصبر لم يكن ضعفًا، بل آلية دفاعية في مواجهة دولة قوية وباطشة. لعقود طويلة، استخدم المصريون "النكتة السياسية" كسلاح لتفريغ الغضب وإسقاط هيبة الحاكم مع الحفاظ على مسافة آمنة. لكن مع مرور الوقت، وتراكم المظالم، لم تعد السخرية كافية.
حدث تحول بطيء ولكنه جذري في النفسية الجماعية؛ انتقل المجتمع من التذمر الصامت إلى السخرية اللاذعة، ومنها إلى الرغبة العارمة في "كسر" القيد. هذا التراكم يفسر لماذا جاء الانفجار دفعة واحدة وشاملاً، دون تدرج. خرج المصريون بعفوية مدهشة، لا استجابة لنداء حزبي أو تنظيمي، بل لأنهم استشعروا قوتهم في وحدتهم. كانت "السلمية" خيارًا غريزيًا نابعًا من طبيعة المجتمع المدني الذي يقدس الاستقرار ويمقت الفوضى حتى في ذروة غضبه، فكان الهدف إسقاط النظام السياسي وليس هدم الدولة، وهو ما تجلى في تنوع أدوات التعبير من هتاف وموسيقى وصلاة، حيث انصهرت الفوارق الطبقية والأيديولوجية لترسم لوحة وطنية جامعة.
مأزق "العفوية".. انتصار الرمز وهزيمة المؤسسة
رغم العظمة الرمزية التي حققتها الثورة، حملت خصوصيتها ذاتها بذور ضعفها. المجتمع الذي نجح بامتياز في "إسقاط الرأس" (مبارك) عبر الضغط الجماهيري الكاسح، وجد نفسه عاجزًا عن "تفكيك الجسد" (الدولة العميقة). الدولة في مصر ليست مجرد حاكم، بل شبكة عنكبوتية معقدة من المصالح والمؤسسات والأجهزة والعقليات الراسخة، وتفكيكها كان يتطلب ما هو أكثر من الحشد في الميادين؛ كان يتطلب تنظيمًا ورؤية سياسية وبرنامجًا انتقاليًا، وهي أدوات افتقدتها الثورة العفوية.
هنا ظهرت المفارقة الكبرى: قوة رمزية هائلة تمثلت في ميدان يهزم جهازًا أمنيًا ونظامًا يسقط في 18 يومًا، يقابلها ضعف مؤسسي واضح تمثل في غياب القيادة الموحدة. العفوية التي كانت سر القوة في الحشد، تحولت إلى عبء في مرحلة البناء. الشعب الذي يمتلك ذكاءً اجتماعيًا فطريًا ويعرف كيف يكسر حاجز الخوف، لم يمتلك الخبرة السياسية الكافية لإدارة مرحلة ما بعد السقوط.
استغلت الدولة العميقة هذا الفراغ؛ تراجعت خطوة للخلف لامتصاص الغضب، وأعادت تنظيم صفوفها، بينما عاد الثوار إلى منازلهم تاركين السياسة بلا حراسة. ومع ذلك، يظل الإنجاز الأهم لثورة يناير ليس في نتائجها السياسية المباشرة، بل في ما أحدثته من تغيير في وعي الشعوب. لقد كانت "ثورة كرامة" رفعت شعار "ارفع راسك فوق أنت مصري" كتحرر نفسي قبل أن يكون سياسيًا. ومهما حاولت الدولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فإن المجتمع الذي ذاق طعم الحرية واحتل الفضاء العام مرة، سيظل يدرك في أعماقه أن الميدان يمكن أن يعود إليه، وأن الدولة -مهما بدت صلبة- قابلة للارتباك أمام إرادة الجماهير.