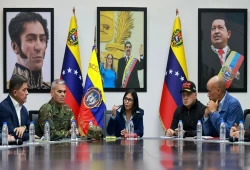تشهد أوروبا في السنوات الأخيرة موجة متصاعدة من التشريعات التي تستهدف المظاهر الدينية للمسلمين، وفي مقدمتها الحجاب والنقاب، تحت عناوين براقة من نوع “حماية القاصرات” و“تعزيز الاندماج” و“الدفاع عن العلمانية”. آخر حلقات هذه السلسلة كان قرار البرلمان النمساوي حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون 14 عامًا في المدارس، بعد أن أعاد تمرير قانون جديد أوسع نطاقًا من الحظر السابق الذي أسقطته المحكمة الدستورية باعتباره تمييزيًا.
الحكومة النمساوية، مثل حكومات أوروبية أخرى، تبرّر هذه الخطوة بأنها تهدف إلى حماية الفتيات من “الضغط الأسري” وإفساح المجال أمام “حرية الاختيار”. لكن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ترى العكس تمامًا: قوانين تحرم الفتيات من حقهن في التعبير عن معتقداتهن، وتجعلهن يدفعن ثمن صراعات الهوية والسياسة، وتدفع بعضهن إلى ترك التعليم بدل “الاندماج” المزعوم.
حماية الفتيات أم معاقبتهن؟ قرار الحجاب في النمسا تحت المجهر
القانون النمساوي الجديد يمنع الفتيات دون 14 عامًا من ارتداء الحجاب “الذي يغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية” في جميع المدارس، ويُلزم أولياء الأمور بضمان التزام بناتهن بالحظر، تحت طائلة الغرامة. هذه الصياغة تكشف أن المستهدف عمليًا هنّ المسلمات فقط، إذ لا يشمل الحظر الرموز الدينية الأخرى بذات الصرامة، ما يعزز قناعة النقاد بأن القانون يخاطب الإسلام تحديدًا لا “الرموز الدينية” عمومًا.
منظمة العفو الدولية حذّرت مرارًا من أن حظر الحجاب، سواء في أماكن العمل أو المدارس، “ينتهك الحق في حرية الدين والمعتقد، ويؤدي إلى مزيد من التهميش بدل الاندماج”، مؤكدة أن مثل هذه السياسات قد تدفع بعض الفتيات إلى الانسحاب من التعليم إذا وُضعن أمام خيار قاسٍ بين هويتهن الدينية ومقاعد الدراسة.
في النمسا، عبّرت منظمات مجتمع مدني وجمعيات نسوية عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي تطبيق القانون إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع، وزيادة شعور العائلات المسلمة بالاستهداف، خاصة مع فرض غرامات على أولياء الأمور بدعوى “حماية الفتيات”. هذه الجمعيات تذكّر بحقيقة بسيطة تتجاهلها الحكومات: حماية الفتيات لا تتم عبر التحكم في ملابسهن، بل عبر ضمان تعليم آمن، ومناهج تحترم التنوع، وسياسات تدعم حقهن في الاختيار لا تُصادره.
من الحجاب إلى النقاب والرياضة.. اتساع دائرة التجريم الرمزي
القضية لا تقف عند حدود النمسا. ففرنسا كانت من أوائل الدول التي سنت قوانين تحظر النقاب في الأماكن العامة، تحت شعارات مثل “العيش المشترك”، وهو ما اعتبرته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش انتهاكًا لحقوق النساء المسلمات، وتمييزًا مقنَّعًا يغطيه خطاب عن “الأمن” و“المساواة بين الجنسين”.
لاحقًا تمدّد الجدل إلى ساحات الرياضة؛ حيث ناقش برلمانيون فرنسيون مشروع قانون لحظر “الملابس الدينية الظاهرة” في المنافسات الرياضية، ما يعني عمليًا استبعاد المحجّبات من كثير من الأنشطة الرياضية الرسمية. وقد وصفت العفو الدولية هذه التوجهات بأنها تقييد تعسفي لحرية الدين، وإقصاء للنساء المسلمات من الفضاء العام باسم “الحياد” و“العلمانية”.
هيومن رايتس ووتش، في تقارير حول القيود على اللباس الديني في دول أوروبية منها فرنسا وبلجيكا، شددت على أن هذه القوانين “تستهدف المسلمين بشكل غير متناسب، وتخلق بيئة قانونية تمييزية”، محذرة من أن الربط التلقائي بين الحجاب والقمع هو اختزال أيديولوجي يتجاهل اختيارات النساء الشخصية، ويحرمهن من تعريف ذواتهن وهوياتهن وفقًا لقناعاتهن الخاصة.
بهذا المعنى، تتحول هذه السياسات من مجرد “تنظيم للفضاء العام” إلى شكل من أشكال العقاب الرمزي الذي يرسل رسالة واضحة للفتيات والنساء المسلمات: وجودكن مرئيًّا بهويتكن الدينية غير مرحّب به.
بين العلمانية والتمييز المقنّع.. هل تفقد أوروبا صورتها كفضاء للحريات؟
الخطاب الرسمي في أوروبا يصرّ على أن هذه القوانين تنطلق من مبادئ العلمانية و“حياد الدولة” تجاه الأديان. لكن منظمات حقوقية أوروبية ودولية تذكّر بأن العلمانية، في جوهرها، تهدف لحماية حرية المعتقد ومنع فرض دين أو حظر آخر، لا لفرض نموذج لباس واحد ولا لتجريم ممارسة دينية بعينها.
كما قال نيلس موزنيك، المفوض السابق لمجلس أوروبا لمكافحة العنصرية، عندما تتحول الممارسات الدينية إلى موضوع للتجريم، نكون أمام “تمييز مؤسسي واضح”، لأن الدولة تستخدم أدواتها القانونية لإقصاء مجموعة بعينها من المجال العام تحت شعار “القيم المشتركة”. هذا ما يتجلى اليوم في قرارات لا يمكن فصلها عن صعود التيارات اليمينية الشعبوية، واستثمار قضايا الهوية والهجرة والإسلام في الحملات الانتخابية وخطابات التحريض.
في النهاية، يطرح كثير من الحقوقيين سؤالًا مقلقًا: إلى أي حد يمكن لأوروبا أن تستمر في تقديم نفسها كنموذج للحريات وحقوق الإنسان بينما تُشرعن، خطوة بعد أخرى، قوانين تفرض على الفتيات المسلمات ما يجب أن يرتدينه أو يخلعنه؟
إذا لم تُراجع هذه السياسات قبل أن تترسخ، فإن القارة التي تباهت طويلًا بأنها “ملجأ المضطهدين” قد تتحول تدريجيًا إلى فضاء يُقصي الأقليات الدينية باسم الاندماج، ويستبدل شعار “الحرية الدينية” بمنطق: حرية للجميع… إلا من يختار أن يكون مختلفًا.