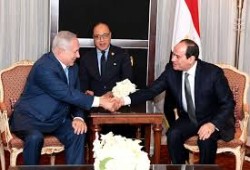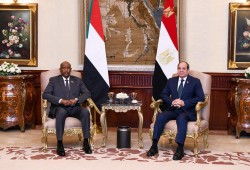أشعل تصديق عبدالفتاح السيسي على القانونرقم 168 لسنة 2025 الخاص بـ“بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة” غضبًا واسعًا لأن جوهره لا يقف عند تسوية نزاعات قديمة على الأراضي، بل يرسّخ هيمنة المؤسسة العسكرية على قرار الأرض والصفقات المرتبطة بها.
بنية القانون وتوقيته يكشفان رسالة سياسية واقتصادية واحدة: تسريع البيع، تحصين الصفقات من الطعن، وجعل الخصخصة قدرًا محتوماً.
وقد أكدّت تغطيات صحفية أن القانون أُقِرّ منتصف أغسطس 2025، فيما أشار تحليل مستقل إلى أن وزارة الدفاع تحتفظ بالكلمة الأخيرة في أي تصرف يتعلق بأراضي الدولة، بدعوى “اعتبارات الدفاع الوطني”، وهي صياغة تعيد إنتاج منطق السيطرة الأمنية على المجال الاقتصادي من الثورة المضادة إلى “دسترة” الدور العسكري (2013–2019) منذ 2013، تحوّل الجيش من فاعل أمني إلى مُشرِّع للاقتصاد وحاكم لحقول الربح عبر سلسلة تعديلات دستورية وقانونية.
التعديلات الواسعة عام 2019 منحت القوات المسلحة لأول مرة مهمة “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وأبقت على اتساع اختصاص القضاء العسكري، بما في ذلك محاكمة المدنيين في قضايا تُصنَّف “عسكرية”، ما رسَّخ وضعًا فوق-مدني يتيح للمؤسسة أن تتدخل حيث تشاء في لحظات تعريف “الأمن القومي”.
هذا التوسّع لم يكن رمزيًا؛ إنه إطار قانوني يسمح بتبرير امتداد اليد العسكرية إلى ملفات حساسة: من الإعلام إلى الاستثمار والأرض.
هذا “التتويج الدستوري” جاء متوازيًا مع نمو اقتصادي عسكري متشعّب منذ 2014 من المقاولات والطرقات إلى مواد البناء والطاقة واللوجستيات في سوق تتغير قواعده لمصلحة فاعل ذي امتيازات سيادية غير خاضعة لشروط المنافسة والشفافية المعتادة.
دراسات متخصصة حذّرت مبكرًا من أثر هذا التمدد على حقوق المستثمرين والحياد التنافسي، واعتبرته انحرافًا هيكليًا يُضعفالملكية الخاصة ويشوه ديناميات السوق.
قانون “وضع اليد” كأداة سيطرة على الأرض… لماذا الآن؟
تاريخيًا ظلّ ملف “وضع اليد” خليطًا من النزاعات العرفية والاعتداءات والتداخلات الإدارية. الجديد أن قانون 2025 يُحوِّل هذا الملف إلى رافعة مالية وسيادية: فكل تصرف جوهري في أراضي الدولة يمر عبر ختم وزارة الدفاع، بحجة حساسية الأراضي الصحراوية وارتباطها بالدفاع، وهو منطوق قريب مما كُرِّس في قانون 2017 لكنه الآن يأتي أكثر صراحة واتساعًا مع حزمة تشريعات موازية، بينها قانون الهوية العقارية الموحدة الذي يعيد ترقيم وتعيين كل أصل عقاري في البلاد لتعظيم القابلية للتصرف والبيع.
المعنى السياسي: تجفيف مساحات المنازعات وخلق “سجل ذهبي” للأرض يسهل التنازل عنه لمستثمرين محلّيين وأجانب ضمن مسار الخصخصة.
بهذا المعنى، لا يعالج القانون فوضى قديمة فحسب؛ إنّه ينقل “الأرض” إلى مدار الأمن القومي، بحيث تصبح قرارات البيع والتسوية محصّنة عمليًا من الرقابات المدنية والقضائية العادية، أو على الأقلّ معقّدة بما يكفي لردع الطعون الفعّالة.
وهو ما يفسر الغضب الشعبي: فالسلطة لا تُقنّن فحسب، بل تُغلق الباب أمامالمراجعة والتصحيح.
من “الهيمنة الأمنية” إلى “الاقتصاد المُحصّن”
تراكم الخطوات من تعديلات الدستور (2019)، إلى تمدد الشركات والأذرع العسكرية في السوق، وصولًا إلى قانون “وضع اليد” (2025) والهوية العقارية—يصنع نموذج دولة يُعاد فيها تعريف الملكية العامة والخاصة عبر عدسة الأمن القومي. النتيجة ليست فقط إضعافًا للحكم المدني، بل إعادة ضبط لعقد المواطنة:
- الأرض لم تعد موردًا تُديره حكومة خاضعة للمساءلة بقدر ما أصبحت أصلًا استراتيجيًا تتحكم في بوابته جهة عسكرية.
- الخصخصة لم تعد خيار سياسة اقتصادية قابلاً للمراجعة، بل مسارًا محصَّنًا بمسوّغات دستورية وقانونية تُجرِّم الاعتراض العملي عليه.
- السوق لم يعد منافسة حرة بقدر ما هو مجال امتيازات حيث الفاعل الأقوى (المؤسسة العسكرية وشركاؤها) يكتب قواعد اللعبة.
تحذّر مراكز بحث من أن هذا النمط يُضعف الاستثمار المنتج طويل الأجل ويشوّه البيئة التنافسية، ويزيد من هشاشة حقوق الملكية في مواجهة القرارات السيادية؛ أي اقتصاد مُحصَّن سياسيًا لكنه هشّ تنمويًا على المدى المتوسط.
ما جدوى هذا القانون والسيسي يبيع أصول الدولة منذ زمن؟
الجواب: جاء ليُسرّع البيع، ويُحصّن الصفقات من أي طعن، ويجعل الخصخصة قدرًا محتوماً لا رجعة فيه.
هو ليس “حلًا إداريًا” لنزاع قديم على الأراضي، بل ترسيمة سيادية تنقل الملكية وقرار التصرف من مؤسسات مدنية قابلة للمحاسبة، إلى ممر أمني-عسكري مغلق.
في المدى القصير، قد يوفّر سيولة واستقرارًا تفاوضيًا للصفقات الكبرى؛ لكن في المدى الأبعد، يكرّس عسكرة الحوكمة الاقتصادية، ويعيد تعريف الحق في الأرض بوصفه امتيازًا يمر عبر الدفاع لا عبرالقانون والمواطنة.
وهذا هو جوهر الغضب الشعبي: ليس على “التقنين” كفكرة، بل على من يحتكر الحق في تقرير مصير الأرض ومن أجل ماذا.